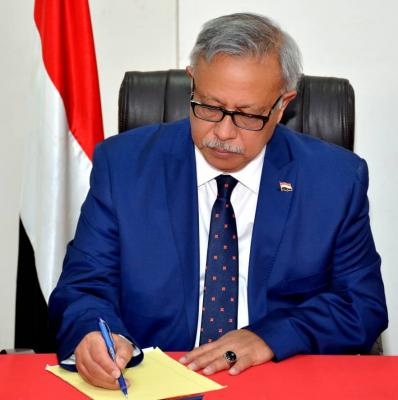الدروس الإسرائيلية والاقليمية من حرب الصيف في لبنان بعد مرور أربعة أشهر على «حرب الصيف» بين إسرائيل و «حزب الله»، وهي أطول حرب شنتها الدولة اليهودية منذ سنة 1948، والوحيدة التي فشلت خلالها في تحقيق أي تقدم عسكري، يبدو أن التشاؤم يلقي بظلاله على مدينة القدس. لكن ما من شك بأن الشرائح التي تشكل النسيج الاجتماعي للقدس لا تزال مفعمة بالحيوية أكثر من أي وقت مضى. عندما يعود المرء إلى هنا، في أعقاب مناظرة حول الصراع العربي – الإسرائيلي في قاعة محاضرات تبعد آلاف الكيلومترات، يشعر بشيء من الحيرة والارتباك، وكأن كل نقاش هنا يدور بين باحثين أكاديميين. نادلة إسرائيلية، قدم أهلها من سورية، تصر على أن الانقسام القديم بين اليهود السيفارديم والأشكيناز، والذي دام حتى الستينات، لم يعد أمراً بذي أهمية بالنسبة لجيلها. وعلى رغم أن والديها اللذين تعيش معهما اليوم هما من سورية، فهي وأبناء جيلها يشعرون بأن مصيراً مشتركاً يجمعهم في بوتقة واحدة مع يهود أوروبا، وقد برز هذا الجانب من خلال الرحلة المدرسية التي قامت بها إلى معسكر «أوشفيتز»، شأنها شأن معظم الشباب الإسرائيلي اليوم. «شعرت وكأنهم قتلوا أقاربي»... هكذا عبرت النادلة عن شعورها. هذه الشابة طالبة في كلية الحقوق، ترتاد النادي الرياضي يومياً. وعندما قلت لها إنني أقمت في اليمن، ارتسمت ابتسامة عريضة على وجهها حين استعادت الفترة التي أمضتها مع صديقها اليمني في موشاف، وهي مزرعة إسرائيلية شبه مشتركة حيث، كما في اليمن، كان الرجال يمضغون نبتة القات المخدرة التي تزرع وتباع بكل حرية في إسرائيل. وقالت لي إن السنتين اللتين أمضتهما في الجيش، في غزة، كانتا أفضل سنوات حياتها. وفي لقاء آخر، أمتعني سائق سيارة أجرة عربي، عاشت عائلته في القدس منذ أجيال، بقصص عن وقاحة السياح الغربيين أنصار الإسرائيليين، الذين عادة ما يتلقون صدمة عندما يعلمون أن سائقهم عربي. بدأ السائق حديثه قائلا إنه ليس فلسطينيا بل عربيا إسرائيليا من منطقة في إسرائيل ضمت في العام 1967، كما أنه لا ينتمي إلى شريحة العرب الذين نالوا الجنسية الإسرائيلية سنة 1948. إذ هؤلاء يخدمون في الجيش الإسرائيلي، على عكس الفئة التي ينتمي إليها والتي تحمل الجنسية من دون أن يحق لها المشاركة في الجيش. لكن عندما قلت له إنني قابلت عرفات مرتين، مرة في الأردن سنة 1969، ومرة أخرى خلال زيارته الأخيرة إلى لندن سنة 1997، أشرقت عيناه. وأخبرني أنه عندما أُعيد جثمان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية من باريس، ذهب إلى رام الله ووقف بين آلاف الفلسطينيين طوال الليل لمشاهدة الطوافة التي أعادت عرفات إلى «المقاطعة»، مقر رئيس منظمة التحرير المدمّر بشكل جزئي. ثم اصطحبني السائق إلى جبل الزيتون والجسر المطل على المدينة القديمة حيث تم تصوير عدد كبير من المقابلات التلفزيونية. ورأيت جبل صهيون وقبر سليمان الفارسي الشامخين من جهة اليسار، وقبة الحرم الشريف الذهبية التي تشرق على الباحة التي يشرف عليها. وسمعت دليلاً سياحياً يقول للسياح إنه من غير الصحيح الادعاء بأن المنطقة التي يشرفون عليها، والتي تضم اليوم مقبرة يهودية، سكنها العرب في الماضي. ويضيف مؤكدا أن مارك توين قال لدى زيارته القدس سنة 1863، إن ما من عربي عاش يوما خارج أسوار المدينة. وإن كانت اتهامات الدليل السياحي أشبه بالمسيحيين الإنجيليين القاطنين في فندق إيرساتز - أورينتال الذي نزلت فيه، حيث - شأنه شأن سائر الفنادق - لا وجود لأي صحيفة أكانت أجنبية أو محلية، لن يجد الدليل السياحي صعوبة في إقناعهم. إذ أنه من الواضح أن الزائرين ليسوا مهتمين بإسرائيل أو فلسطين المنبسطة أمام أعينهم، بل إنهم أتوا إلى هنا ليروا بأم العين كيف عاد اليهود إلى «أرضهم الأم». ويبدو أنهم اطمأنوا الى ما شاهدوه، ولو أنهم شعروا بشيء من الحيرة أمام ما شاهدوه. أما من الجانب الإسرائيلي، فتسود أجواء من الاتهام السياسي المضاد وإعادة التنظيم العسكري. وعلى عكس العقود الأولى التي تلت ولادة إسرائيل، هنالك اليوم غياب واضح للقادة والشخصيات العسكرية أو المدنية البارزة. ويستمر الجدل الإسرائيلي حول الجهات المسؤولة عن الأخفاق في حرب تموز في الإعلام وداخل مجلس النواب؛ كما يستمر الإسرائيليون في التقليل من شأن رئيس الوزراء إيهود أولمرت الذي وصفه أحد أصدقائي بأنه «محام كان يجيد تقديم المشورة لزبائنه ليجنبهم السجن، لكنه ليس قائداً عسكرياً». وفي حين يقوم عدد كبير من لجان التحقيق اليوم في النظر في الجوانب التقنية للحرب، يتصرف القادة العسكريون وكأنهم قادة عصابات، كل منهم مع مجموعته من الصحافيين الذين يسعون إلى إظهارهم تحت أفضل صورة أمام الرأي العام. في هذه الأثناء، يقف نتنياهو مترقباً فرصته، غير أنه يفتقد هو أيضا إلى المصداقية. إن تصلب موقف الحكومة هو إحدى النتائج المباشرة لإخفاق الإسرائيليين خلال الصيف. قبل اندلاع «حرب الصيف»، وفي محاولة لتسويق صيغة «ليبرالية» لخطة شارون للانسحابات الجزئية من المستوطنات، تحدث أولمرت عن احتمال إخلاء بعض الأجزاء من الضفة الغربية، إلى جانب الانسحاب من غزة الذي وضعه سلفه. لكن الآن، لم تعد هذه المسائل مطروحة، نظراً الى أن الانسحاب من غزة سنة 2005 ومن لبنان سنة 2000 جعل الإسرائيليين يبدون ضعفاء في نظر العرب. وفي خطوة تنذر بالشؤم إزاء المستقبل، وتشرع ما كان يعتبر حتى اليوم أمراً غير مقبول عموما، أو أقله كموضوع لا تصح مناقشته، تم تعيين المهاجر الروسي أفيغدور ليبرمان في حكومة أولمرت. ويقول ليبرمان إنه يريد تطبيق الاستراتيجيات التي استخدمها الروس في الشيشان على الفلسطينيين، ودفع العرب خارج إسرائيل. وليس من الضروري التنويه بأنه يدعم فكرة قصف إيران دعما كاملا، وهو أمر في غاية الأهمية كون ليبرمان تسلم حقيبة التخطيط الاستراتيجي الطويل الأمد. غير أن هذا الخلاف الإسرائيلي والغموض المخيّم يخفيان حقائق أخرى سائدة منذ زمن طويل. أولى هذه الحقائق، والتي سارع صديق لي من حيفا الى إطلاعي عليها، هي أن الحرب أظهرت نقطة ضعف الإسرائيليين أكثر من أي وقت مضى. إذ بات جليا أنه ليس هنالك من منظومة دفاعية صاروخية قادرة على حماية كل المدن الموجودة شمال البلاد. فقد ترك قصف الكاتيوشا، وغيرها من الصواريخ الذي انهال على المدن الإسرائيلية طيلة شهر كامل جروحاً عميقة ليس بسبب عدد الضحايا الذي كان ضئيلاً نسبياً، بل بسبب عجز الحكومة أو الشعب، عن التصدي لهذه الهجمات. وأخبرني صديقي كيف أن الملاجئ التي أمضى فيها السكان ساعات طويلة كانت قذرة وغير مجهزة (وكانت عائلته تمتلك ملجأ خلف الشقة وكانت تستخدمه كغرفة تخزين، لذا فإنها لم تتمكن من تفريغه في الوقت اللازم). وشعر سكان الشمال الذين انهارت عليهم القذائف وكأن قادتهم في القدس وفي الجنوب فقدوا القدرة على التعاطف معهم. وخلال الساعة أو أقل التي كان يقضيها متوجهاً في سيارته إلى عمله في تل أبيب، وسط الأجواء المتشنجة كالعادة، ازداد اقتناعه بأن شعبين مختلفين تماما يعيشون على هذه الأرض الواحدة. أما الحقيقة الثانية والأخطر، فهي أن معظم الناس يتوقعون الآن اندلاع حرب أخرى خلال سنة 2007 أو 2008. وعبارة «المهمة لم تنجز بعد» تتردد على كل لسان، غير أن ما ينطوي عليه هذا القول ليس جلياً. ما من شك في أن الإسرائيليين قادرون على إعادة تأهيل جنودهم، وحماية دباباتهم وناقلات الجند المصفحة، وتدريب وحدات النخبة في جيشهم على أساليب جديدة لمواجهة المتمردين، لكن، وكما تبين في لبنان، فهم لن يستطيعوا إلغاء «حزب الله» لا كقوة سياسية ولا كقوة عسكرية. إن حرب الصيف التي هدفت بصورة أساسية إلى فرض تدخل دولي ولبناني في مسألة جنوب لبنان للسيطرة على «حزب الله» لم توصل الإسرائيليين إلى الغاية المرجوة. وتظهر الأزمة السياسية القائمة حالياً في لبنان أن ذلك ناجم عن مشكلة قديمة لم ينجح أحد، لا سورية، ولا إسرائيل، ولا حتى فرنسا من قبلهما في حلها، ألا وهي الضعف الذي تعاني منه الدولة اللبنانية. لكن عاجلاً أم آجلاً، ستؤدي محاولة «إنجاز المهمة» إلى مواجهة مع سورية، أو مع إيران. والمعضلة التي يواجهها الإسرائيليون، وكذلك الأميركيون، هي أنه في حال مارسوا ضغوطاً كبيرة على سورية، سيؤدي ذلك إلى إضعاف نظام بشار الأسد، ما سيدفع الأخوان المسلمين، أبرز أطراف المعارضة في البلاد، إلى الحكم. أما بالنسبة إلى إيران، فليس من المستبعد أن تشن إسرائيل غارات جوية على منشآتها النووية، بهدف إعاقة، ولو موقتاً، قدرة البلاد على إنتاج السلاح النووي. كذلك، يمكن الافتراض أن إسرائيل ليست الوحيدة التي استخلصت العبر من حرب الصيف، بل إن الأطراف الإقليمية الأخرى، لا سيما إيران وحلفاؤها، قد توصلوا الى استخلاص العبر نفسها. وهنا تأتي ثالث وأهم نتائج الحرب وهي أن الخطة الاستراتيجية للشرق الأوسط التي تأقلم معها كل من إسرائيل والدول العربية والفلسطينيين والعالم الخارجي منذ سنة 1967، تغيرت اليوم إلى حد كبير، أو حتى بصورة جذرية، كما يعتقده البعض. ووراء هذا التغير سببان. أولاً، لم تعد المسألة مسألة نزاع بين العرب والإسرائيليين، بل بين إسرائيل وإيران، التي هي في صدد تطوير استراتيجية تمدد من العراق إلى غزة صممت لإضعاف الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. وثانياً، إن الادعاءات التي ترددت في فترة ما بعد 1967 حول مساومة لتبادل الأراضي، وقرارات الأمم المتحدة، والسعي إلى التوصل إلى اعتراف متبادل بالدولتين، والضمانات الدولية، لم تعد قائمة اليوم. وتواجه إسرائيل الآن، من جهة إيران وحليفيها «حزب الله» و «حماس»، عدواً لم تشهد مثل عزمه وتنظيمه وتصلب مواقفه عند أي من الأعداء الذين واجهتهم منذ تأسيسها. وتشكل إيران اليوم صلب النقاش العام الدائر في إسرائيل، وقد تمّ تهميش الحرب العراقية على حساب الملف الإيراني، مع أن الوضع في العراق أكثر خطورة ومن شأنه أن ينعكس مباشرة على الدول المجاورة لإسرائيل، أي سورية والأردن، ويعزز قوة إيران الإقليمية. غير أن أفراد القوى المسلحة الإسرائيلية الذين كان لهم اتصال مع سجناء ومناضلين من حركة «حماس» فهموا أنهم في مواجهة عدو أكثر عزما. ويتضح من الخطة الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها إسرائيل أنه ليس أمامها سوى خيارات صعبة. ويبدو ان الأمر ستكون له انعكاسات على حيوية إسرائيل نفسها. فالاتفاقات التي وقعت أوائل التسعينات أعطت آمالاً جديدة إلى الفئة العلمانية من المجتمع الإسرائيلي، لا سيما الليبراليون ورجال الأعمال الذين جعلوا من إسرائيل قوة اقتصادية ناجحة. غير أن هذه الآمال اضمحلت اليوم، وباتت قلة من الإسرائيليين تبدي استعدادها لوضع ثقتها في الفلسطينيين مجددا. وقال لي استاذ جامعي إسرائيلي رأى الموت أمام عينيه خلال الحرب «أعتقد أنه علينا الانتظار ومتابعة القتال لثلاثين أو أربعين عاماً إضافية لنتوصل إلى حل في الشرق الأوسط». ولم أجرؤ أن أقول له إنني وجدته متفائلاً أكثر من اللازم. وفي الوقت عينه، تركت نسبة كبيرة من الإسرائيليين البلاد، ربما ما نسبته 20 في المئة أو أكثر، من دون الاعتراف بأنهم هاجروا نهائيا، لكن من دون التأكيد أيضاً بأنهم سيعودون. ويشكل هؤلاء «المتحدرون»، أو «يورديم»، وهو المصطلح الصهيوني المستخدم للإشارة إليهم، إلى جانب نسبة الولادة المرتفعة جدا عند الفلسطينيين، النقطتين الأضعف في المجتمع الإسرائيلي. وأقل ما يقال عن وجهة نظر العرب أنها أصبحت متصلبة أكثر من أي وقت مضى. إن فوز «حماس» في الانتخابات النيابية وخروج «حزب الله» من حرب الصيف «بنصر إلهي»، بحسب وصف الحزب نفسه، منحا الفلسطينيين حساً جديداً بالثقة، مع أن هذين العاملين دفعا الآخرين إلى حالة من اليأس. وخفتت أصوات بعض الذين أبدوا، في فترة ما بعد 1967، رغبتهم في الاعتراف بدولة إسرائيل والتوصل إلى نوع من المساومة على الأراضي. إذ تصرّ حماس على أن كل الأراضي التابعة لفلسطين ما قبل 1948 هي «وقف إسلامي». وقد حاول عرفات في أوسلو التفاوض بدهاء لتخطي مسألة حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، غير أن الموضوع عاد في أوائل التسعينات ليشكل نقطة خلاف رئيسة بين الطرفين. هذه الأجواء الجديدة نقلها لي صديق قديم، كان في السابق من المثقفين الذين يدافعون عن وجهة نظر «فتح»، عندما زارني ذات يوم مصطحباً معه شاباً ملتحياً تبدو ملامح الثقة على وجهه. وقدم صديقي هذا الشاب كمتخصص في الفكر الاسلامي، وفي «الهدنة» على وجه الخصوص، وهو مصطلح شائع في العربية الفصحى وفي القرآن، تستخدمه حماس بكثرة للدلالة على أن التسوية مع إسرائيل لا تلقى أي اعتراف. وسألني الشاب: «لماذا ينبغي على حماس التعاون مع بقايا «منظمة التحرير الفلسطينية» الفاسدة؟»، في تلميح إلى التكهنات التي تحدّثت عن تحالف بين «حماس» والحرس القومي القديم. فالرئيس عباس كان مجرد دمية في أيدي الأميركيين والإسرائيليين. أما «حماس»، فهي تزداد قوة يوماً بعد يوم، على رغم الضغوط الإسرائيلية. وشدد قائلاً: «لديهم دعم الناس، ولديهم الأصوات والأسلحة والمال»، مضيفاً أن إيران وبعض الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وعدوا جميعاً بتقديم الدعم المالي لحكومة «حماس». وفي خطوة تبدو وكأنها تؤكد على هذا المنحى، ترك رئيس الوزراء هنية غزة لمدة شهر متجهاً إلى الشرق الأوسط، لا سيما طهران. وهذا دليل على مدى جدية هذه الرحلة الهادفة إلى جمع الأموال، وكيف ان حركة «حماس» المتأنية كانت على وشك التوصل الى حل سياسي في صفوف الفلسطينيين. وبدا أن الشاب الملتحي كان سعيداً بدعم أقواله. في الواقع، كل ذلك ينذر بنهاية غير مستحبة: أن الحافز وهامش تحرّك الوساطة الديبلوماسية الخارجية بات ضيقاً جداً. وبعيداً عن وقف إطلاق النار وبعض التخفيف من الضغوط الاقتصادية المفروضة على الفلسطينيين، يبدو أن أحدا من الطرفين غير مهتم في الوقت الحالي، وعلى الأرجح لفترة طويلة من الزمن، في التوصل إلى تسوية جدية لحل الأزمة. لذا، فإن أراد المرء التمتع بأجواء مرحة وسماع أخبار جيدة خلال هذه الفترة، فمن الأفضل عدم التفكير بالقدوم إلى الأرض المقدسة، أقله ليس هذه السنة، ولربما ليس خلال السنوات القليلة المقبلة. * أكاديمي بريطاني متخصص في شؤون الشرق الأوسط. عن الحياة اللندنية |

| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||