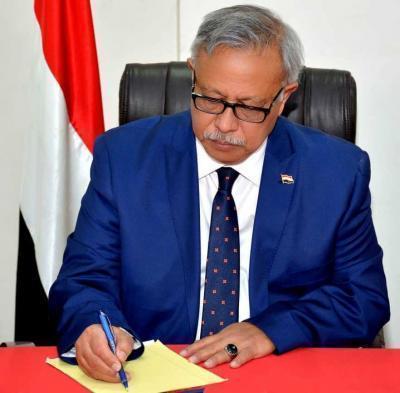إنها ليست أزمة وحدة..! واحدة من الإشكاليات التي تواجهها الدول الحديثة العهد بالديمقراطية، أو كما يسمونها دول الديمقراطيات الناشئة، هو انخفاض مستوى الوعي السياسي العام دون الحد الآمن لاستيعاب الديمقراطية كفلسفة ثقافية، ومنهج سلوكي، الأمر الذي يحرفها إلى غير غاياتها المنشودة ويزج بلدانها في أزمات وإشكاليات جراء إخفاق القوى السياسية والمدنية في استلهام الفحوى الفكري والأخلاقي للديمقراطية. فعندما يجري الحديث اليوم عن مشاريع سياسية صغيرة، ودعوات تشطيرية، وتآمرات على اليمن، وتصبح الوحدة هي محور كل الجدل الوطني القائم، فإن الأزمة هنا-بلا أدنى شك- ليست أزمة وحدة، كما يتم الترويج لها، بقدر ما هي أزمة وعي سياسي وديمقراطية لدى القوى الوطنية السياسية والمدنية، تلقى بظلالها على كل مقدرات الحياة اليمنية، وليست الوحدة وحسب.. فما نسمع من تصريحات وخطابات، ونقرأ من بيانات وكتابات، كلها تتناول قضية الوحدة كحلقة واحدة فقط من بين حلقات كثيرة تتجاوز أطروحاتها الجغرافيا، إلى التاريخ لتعيد قراءته بخيالاتها الخاصة، ثم تمتد إلى الدين والمذاهب والأصول العرقية، ولا تترك شيئاً من حياتنا اليمنية إلا وتتناوله بهالة ضخمة من التشكيك والترويع والانفعال، كما لو أننا مطالبون بالانسلاخ الكامل من واقعنا والبدء من الصفر مجدداً على هدى ما تتناوله الأطروحات الجديدة القائمة. إذن لا بد من فهم ما يحدث على أنه تسفيه لوجودنا الحضاري، والإنساني، وتاريخنا وجغرافيتنا وثقافتنا، وحتى لعلاقتنا الاجتماعية والأسرية، التي لم تسلم من التحريض، وتأليب الأزواج على بعضهما بمنطلقات مناطقية ومذهبية وثقافية، وسياسية.. وبالتالي فهي أطروحات هدامة لكل أساسات حياتنا، وليست للوحدة الوطنية وحسب، غير أن نفس القوى المروجة لهذه الأطروحات تحاول بشتى الوسائل، والحيل، إقناع الرأي العام بأنها أزمة وحدة وطنية ليس أكثر، بغية تضليله والنأي بأنظاره وتفكيره بعيداً عن حقيقة ما يتم تسويقه وإشاعته في أوساط الساحة الشعبية من أطروحات مختلفة أثقلت كاهل الفرد والمجتمع، وأرهقت تفكيره وضاعفت من قلقه إلى الدرجة التي باتت بعض القوى تحرض مشائخ محافظة على أخرى تحت شعار "التمييز" وتؤلب أبناء مديرية على مديرية أخرى داخل المحافظة الواحدة، وتروج لفتن مماثلة داخل مؤسسة العمل الواحدة. إن هذا يؤكد ما سبق أن ذهبنا إليه من أن الغاية من كل ما يجري هو التفكيك والهدم الكامل للحياة اليمنية، بأدق مفرداتها وأن الأمر ليس أزمة وحدة الثاني والعشرين من مايو 1990م، أو تداعيات حرب صيف 1994م، أو إحداث الفتنة في صعدة، كما يجري طرح بعض القوى، فإشكاليات هذه الأحداث ليست أكثر من ظهر جمل تمتطيه لبلوغ المآرب الأخرى. ومن المؤسف أن النخب السياسية والثقافية لم تلتفت في وقت مبكر إلى قائمة الأطروحات الأخرى التي يتم حشرها تحت سقف أي حدث عن الوحدة اليمنية، أو الأحداث التي شهدتها بعض المدن الجنوبية، كما أغفلوا تعقب البدايات الأولى لهذه الأحداث، والظروف التي تهيأت لاذكائها والأطراف التي تبنت على عاتقها صناعة تلك الظروف، وبالتالي فإن محاولة إيجاد تفسيرات للأحداث، واقتراح حلول من خلال قراءة متأخرة جداً، ومقتطعة من المنتصف، لا يمكن أن يفضي إلى استيعاب سليم للمشكلة، ومخارج آمنة لكل الأخطار المحدقة بالوطن، لأن الجهل بمنشأ المرض يعجز الطبيب عن تشخيص العلاج، أو يضطره إلى التخمين. الذي لا يخلو من المجازفة. وعليه يستوجب على نخبنا السياسية والثقافية ألاَّ يعولوا على الظاهر من القول أو على التحليلات الجاهزة التي تقدم لهم بطبق من ذهب، وبإيحاءات على أنها مسلمات، وبديهيات جازمة، لأنها عادة ما تكون قراءات مبتورة، ومبنية على تداعيات متأخرة وليست على الأرضية التي غرست فيها البذرة الأولى للفتنة، بل إن على هذه النخب أن تسبر الأغوار، وتتأمل الأحداث جيداً، وكل ما يتم طرحه من أجل الوقوف على آراء سديدة تقود إلى خلاصات موفقة وحكيمة، يسهل بناء الرؤى الثقافية على أساسها. فكما ذكرت في البداية حول إشكاليات انخفاض الوعي السياسي في بلدان الديمقراطيات الناشئة، فإننا نجد أنفسنا اليوم وجهاً لوجه مع تلك الإشكالية، جراء سوء تعاطي البعض مع الديمقراطية، وعدم إدراكه لغاياتها الحقيقية، وادواتها الآمنة.. وبالتالي فإن العبث السياسي والممارسات غير المسئولة تحت سقف الحريات الديمقراطية، ظلت غالباً وراء صناعة الكثير من الإشكاليات والأزمات، وتعريض الشعوب لمخاطر تهدد أمنها واستقرارها وربما حتى سيادتها وهويتها الوطنية..! |

| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||