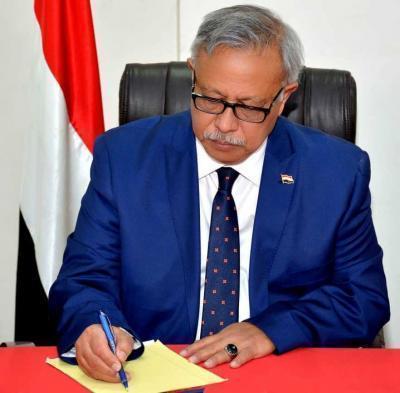من (الباستيل) إلى (الشانزليزيه) و(باب اليمن) ربما لا تمر الذاكرة العربية بالكثير من محطات علاقاتها مع فرنسا، لتعايش حالة القفز فوق العقدة الاستعمارية باتجاه الارتباط العميق مع العرب، والتوغل في نفوسهم إلى حد الانبهار، رغم أن فرنسا وصلت – بأكفها المفتوحة - في زمن متأخر لا يتعدى الثلاثة عقود والنصف من تاريخ السياسة (الديغولية) في معظم الأحيان. وحين يتحدث كُتابنا في اليمن عن محاور التئام القيادتين السياسيتين هذه الأيام وسابقتها نجدهم يحاكون تحليلات آنية، ومواقف سياسية، ومصالح اقتصادية، واستراتيجيات أمنية، و عسكرية من غير استكشاف للخصوصيات الإنسانية والفلسفية لهذا اللون من الانجذاب الثنائي الصريح، والتفاعل الساخن الذي أجلى الوجه الفرنسي، ولمعه على نحو يغمر كل مفردات الذاكرة التاريخية، ويمحو أبجديات الزمن الاستعماري الفرنسي، وطيش العدوان الثلاثي، ومغامرات (سان ريمو) وغيرها. لعل حقيقة الاحترام العربي الكبير، والانبهار بالدور الفرنسي – الهادئ - في الشرق الأوسط لم يكن بالإمكان الوقوف عليه، وبلوغ مآربه لولا أن التاريخ الفرنسي توقف ذات يوم على مدرج ملعب كرة القدم يلوك هموم الشعب الفرنسي، حتى إذا ما جاء أمر صاحب الجلالة لفض الاجتماع، انتصب (ميرابو) صارخاً بوجه رسول الملك:(اذهب وقل لسيدك أننا مقيمون هنا بإرادة الأمة، ولن نبرح أماكننا إلاّ على أسنة الحراب). كانت صرخة (ميرابو) بعد لحظات ميقات صرخات شعب كامل، زلزلت حصون (الباستيل)، وأطاحت بعروش الظلم، وأطلقت نور فرنسا للدنيا- للمرة الأولى.. ومن يومها قدّس الفرنسيون السلام، والحرية ، والحب، فحملوها على دروب التاريخ، حتى وجدوا أنفسهم يوماً على ناصية شارع "الشانزليزيه" يتذوقون الحياة الكريمة على أرصفته المفعمة بمكتسبات الكفاح، والبناء الطويل. الفرنسيون- وإن مرّوا لاحقاً بحقب جدبة، مارسوا فيها لعبة الاحتلال، واغتصاب إرادة بعض الشعوب- إلاّ أنهم ترجموا تقديسهم لتلك القيم بذلك النصب التذكاري الرائع (تمثال الحرية) الذي أهدوه للولايات المتحدة عقب انتهاء حربها الأهلية عام 1866م، رغم أنهم عملوه بهيئة فلاحة مصرية بنية تقديمه هدية لمصر، إلا أنهم –على ما يبدو- أرادوا تصدير ثقافة الحرية للولايات المتحدة الأمريكية، وتذكير الأمريكيين أن هناك، في الجانب الآخر من العالم فلسفة اسمها (الحرية) تختلف تماماً عن ثقافة الحرب الفواحة بعفن الدماء والموت ،التي غرق فيها الأمريكيون لسنوات طويلة. رغم أن الأمريكيين لم يفلحوا في التخلص من أسمال الماضي، لكن الفرنسيين ما لبثوا أن تحرروا من نزوة استعمار الشعوب، وانهمكوا بمشاريع الفكر الإنساني، وتصدير ثقافة السلام، والحرية لشعوب العالم- خاصة النامية منها- لأنهم بلغوا يقين الإدراك بأن الوعي الثقافي سبيل وحيد لتأمين ساحة الكرامة الإنسانية. إن فرنسا على امتداد ما يقارب النصف القرن الأخير – تقريباً- من تاريخها لم تخض حرباً واحدة-سواء داخلية، أم خارجية. ولم تتطرف بموقف سياسي ضد بلد بعينه لأسباب عنصرية، أو دينية، وغيرها، ولم تتورط في أعمال خارج حدود الإجماع الدولي، والشرعية الدولية، رغم كونها عضواً دائماً بمجلس الأمن الدولي، وتمتلك الغطاء السياسي، والكفاية العسكرية للعب مثل تلك الأدوار. لكن فرنسا منذ أواخر الستينات – بالضبط بعد نكسة حزيران- أخذت تلتفت للعالم العربي، وتؤسس لعلاقات متينة قائمة على التعاون، وتبادل المصالح، فضلاً عن تقديم المعونات للكثير منها، مركزة ثقلها في المجالات المعرفية، والثقافية، والإنسانية.. وربما كان توقيت ذلك التوجه باعثاً لتأويله على أنه رغبة في إحياء وجودها السياسي، وموازنة الخرائط التي بدأت ترتسم للشرق الأوسط من قبل القوى العالمية الأخرى، والتي نجم عنها قلق فرنسي عزز ضرورات التشبث الفرنسي بوجوده العسكري القائم في جيبوتي، على الرغم من كون حجم ذلك التواجد ليس بالقدر المكافئ للنفوذ الأمريكي في (غلاسياغوريا) بالمحيط الهندي، أو البريطاني في القاعدة (أرميلا) بالقرب من الخليج العربي، إلا أنه كان يبدو للفرنسيين كافياً لحماية مصالحهم بالمنطقة، وكذا ممرات تجارتهم الدولية التي توصلهم إلى مصادر الطاقة في الخليج. فيما يخص اليمن، فإن فرنسا التي وقعت اتفاقية صداقة وتعاون مع دولة الإمام يحيى عام 1926م كانت دائماً تجد نفسها في صدام بين ما تحمله من انفتاح، وحداثة، وبين ما يحمله الإمام من انغلاق وعقد مع الغرب. لكنها في الأربعينات نجحت في إيصال أكفها الرحيمة لليمنيين، وتشكيل بعثة طبية كبيرة قدمت خدمات جليلة، لا تقدر بثمن، في إنقاذ أروح مئات الآلاف من براثن المرض الذي كان يفتك بهم . كما أصبح هناك الكثير من المهندسين والفنيين الفرنسيين الذين كانوا يقدمون خطط مشاريع تحديثية، وبرامج تنموية تلاقي في أغلبها رفض الإمام الخائف من الأجانب، كما هو الحال مع مشروع سكة حديد الحديدة- صنعاء الذي رفضه الإمام أحمد. لم يأت الاعتراف الفرنسي بالنظام الجمهوري اليمني إلا في عام 1970م، ومنذ ذلك الحين وُقّعت العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات، وأخذ الفرنسيون يتلذذون برؤية الوجه الآخر لشارع (الشانزليزيه) في (باب اليمن) التي طالما ظلت تحيي في ذاكرتهم حقب النضال الثوري الفرنسي، وكبرياء (نابليون بونابرت) وقصص الشرق العربي. فصاروا يقيمون دور الدراسات والبحوث ، ومؤسسات الثقافة والتاريخ، ويدونون الكثير من فصول الحضارة اليمنية. في عام 1977م كانت أول زيارة لرئيس يمني إلى فرنسا ، قام بها المقدم إبراهيم الحمدي ليؤسس الفاصل العصري الجديد بين الانغلاق والانفتاح . وعندما أعلنت اليمن وحدتها المجيدة عام 1990 باركها الفرنسيون، وتحمسوا بعدها للمبادرة الفعلية لشد أواصر العلاقات مع اليمن، فكانت زيارة رئيس وزراء فرنسا لليمن عام 1993م وهي أرفع زيارة رسمية فرنسية في تاريخ اليمن، ثم أعقبها بأخرى عام 1994 لتتوج هذه الزيارات في عام 1996 بزيارة الرئيس الفرنسي (فرانسوا ميتران) لصنعاء، وتلك كانت نقطة الانطلاق الفعلية في قضية جزر (أرخبيل حنيش). لكن بعد تاريخ زيارة (ميتران) لليمن أصبح من ضمن تقاليد الرئيس علي عبد الله صالح الرئاسية أن يزور باريس كل عام ابتداءً من العام 1997م وحتى زيارته الأخيرة هذه الأيام – باستثناء عام 2002م لانهماك اليمن بقضايا وطنية كثيرة جداً. وهكذا أصبح الرئيس علي عبد الله صالح بمثابة الرئيس الأكثر تردداً على باريس، والمُرحَّب به بصورة متزايدة لدى الفرنسيين .. ومن الواضح جداً إن باريس لم تكن لتسمح بذلك لولا أنها وثقت بيقين بالقيادة السياسية اليمنية، وتوجهاتها السلمية، والديمقراطية، والانفتاحية، وأنها تأكدت فعلاً من نضوج الوعي السياسي اليمني لدى الرئيس علي عبد الله صالح، الذي كانت مواقفه تلتقي كثيراً بالموقف الفرنسي الواضح من القضايا المصيرية المختلفة.. فكلاهما ينظر للعلاقات الدولية بعين العدل والمساواة، والتكافل، والانتماء للعالم الواحد، والعصر الواحد، وبنفس القيم الإنسانية النبيلة الصادقة. فبقدر ما تعتز فرنسا باستقلالية موقفها وقرارها السياسي، فإنها كانت تكنّ احتراماً كبيراً لأولئك الذين يعتزون بإرادتهم، ويستقلون بآرائهم، ويحترمون إنسانيتهم على غرار ما تفعل اليمن. من هنا أرى أن العلاقات اليمنية- الفرنسية لا تقوم فقط على مصالح مشتركة، واستراتيجيات أمنية، وعسكرية، وموازنات قوى إقليمية، ودولية، بل أنها تتميز عن سواها بالأفق الإنساني الفكري لقيم الحرية، والسلام ، والتعايش الإيجابي للشعوب ، والأمم ، والإحساس بالآخر بصدق، ووضوح .. وهو – بكل تأكيد - مظلة لقاء الرئيس علي عبد الله صالح بفخامة الرئيس جاك شيراك في باريس. |

| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||