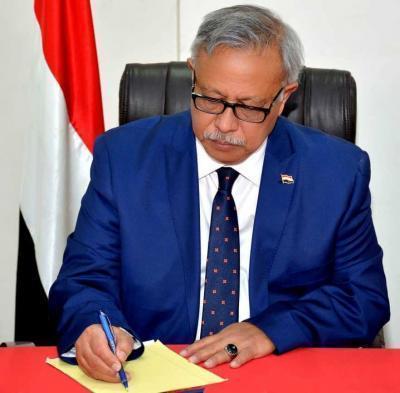الرئاسة الإيرانية بين «الداهية» و«الموظف» تجري الانتخابات الرئاسية الإيرانية خارج «الربيع الديمقراطي» الذي تعهدته الولايات المتحدة في العالم كله وحيال المسلمين والعرب تحديدا. فإيران، بهذا المعنى، ليست يوغسلافيا أو جورجيا أو أوكرانيا، وهي، طبعا، غير العراق وفلسطين ولبنان. ففي هذه الحالات كلها تنسب واشنطن دورا كبيرا إلى نفسها في تعزيز الحريات. وفي ما يخص منطقتنا يتجاهل جورج بوش أن وفاة الرئيس ياسر عرفات استدعت الانتخابات، وأن لبنان يملك تقاليداً في هذا المجال، وأن الانتخابات الوحيدة التي حصلت بدفع أميركي هي العراقية وهي التي أدخلت البلد في أزمة بدل أن تكون مدعاة إلى حل توافقي يرضي الأطراف. الانتخابات الإيرانية خارج هذا السياق الأميركي، لا بل أنها ضده بمعنى ما. لا تستطيع الإدارة إدعاء أي فضل لنفسها فيها. إلا أنه لم يسع المراقب إلا أن يلاحظ أن هذه الانتخابات جديدة بالاسم لسببين على الأقل. الأول هو أنها تقترح خيارات متعددة على الناخب، والثاني هو أنها قابلة لحصول مفاجآت. أما الخيارات فقد عبرت عن نفسها في الدورة الأولى عبر المرشحين السبعة الذين يمثلون أطياف المحافظين والإصلاحيين. أما المفاجأة فهي في انحصار المنافسة للدورة الثانية بين علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمود احمدي نجاد في حين أن التقديرات كانت تشير إلى خلاف ذلك وتتوقع مهدي كروبي أو مصطفى معين. يقال الكثير عن أن هيئات غير منتخبة تتدخل لتصفية بعض المرشحين ومنعهم من خوض السباق، إلا أن التجربة تقول أن هذا التدخل يبقى أقل بما لا يقاس مما يحصل في بلدان «صديقة» للولايات المتحدة ومع ذلك فإن واشنطن تغض النظر أو تبادر إلى امتداح ما تعتبرها «خطوات إصلاحية». لم تكن ظروف الحملة الانتخابية نموذجية طبعاً. ولا ظروف الاقتراع. لقد حصلت مضايقات واستفزازات. وحصلت تدخلات ومحاولات تزوير وعلا الصخب كثيراً. ولم يحظ المرشحون بحظوظ متساوية في وسائل الاعلام. ولقد ادى ذلك كله الى اطلاق تكهنات بأن الايرانيين سيميلون الى المقاطعة الكثيفة احتجاجاً على ما هو حاصل. واحتجاجا ايضاً، على الافشال المتعمد للمشروع الاصلاحي الذي قاده الرئيس محمد خاتمي، وهو افشال لجأ الى وسائل ضعيفة الصلة بالديمقراطية. الا ان المفاجأة حصلت يوم الاقتراع حين تدفق الملايين الى الصناديق وبشكل جعل اي اشارة مسبقة الى النتائج في غير محلها. وادى فرز الاصوات الى حصر المنافسة بين اثنين حصلا، معاً، على نحو اربعين في المئة من اصوات المقترعين في الدورة الاولى. ويعني ذلك ان الاحداث توزعت حسب المشارب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للناخبين، وان هؤلاء اضطروا الى التفكير ملياً في الخصوصية الاصلاحية او المحافظة لهذا المرشح او ذاك. ستشهد الدورة الثانية منافسة بين رفسنجاني ونجاد. الاثنان من «ابناء الثورة الاسلامية». الا انهما ابنان شديدا التمايز. الاول داهية من دهاة إيران ينتمي الى اسرة زراعية وتجارية ثرية ولا يتورع عن زيادة ثروتها. معروف ببراغماتيته الشديدة وبضلوعه في اجتياز كواليس السلطة. تربع على أعلى المناصب لفترات طويلة وعرف كيف يبني مواقع نفوذ له ولمقربين منه. صلاته بأوساط البازار معلنة والرهان معقود عليه للقيام بـ «اصلاحات» اقتصادية ذات طابع ليبيرالي.الثاني هو من «المستضعفين» الذين قيل لهم ان الثورة انما قامت من اجلهم فصدقوا وانخرطوا فيها وعرضوا حياتهم للموت في معاركها الداخلية والخارجية. انه ابن عائلة موغلة في الفقر وقد اعتمد على نضاله من اجل الارتقاء في سلم المناصب والمسؤولية. المعروف عنه تشدده الايديولوجي المبالغ فيه. وهذا وجهه السلبي. اما وجهه الايجابي فهو انه من أبعد الناس عن الاستفادة الشخصية ومن اكثرهم نزاهة ومن اكثرهم حرصاً على جعل الثورة في خدمة فقراء المسلمين. واذا كان الاول يسبب خوفاً لأنه «جامد». نحن اذا امام نموذجين اعتادت الثورات انجابهما، النموذج الذي يراها من فوق بحسناتها وعيوبها فيتعاطى معها براحة. والنموذج الذي يعيش الثورة من تحت فيخشى عليها من الانحراف وينصب نفسه حاجزا دون ذلك. الأول ناور على المرشد والرئيس معا طوال سنوات. وحول نفسه إلى القطب الثالث في النظام الذي يعرف كيف يتقدم وكيف يتراجع واضعا نصب عينيه العودة إلى الرئاسة. الثاني أخلص أشد الإخلاص للمرشد وخاض معركة ضد الرئيس الإصلاحي وارتضى أن يكون فرس رهان عتاة المحافظين في معركة استعادة بلدية طهران. إنها المعركة التي شهدت أقل نسبة اقتراع، كما أنها المعركة التي يؤرخ بها لأفول «الخاتمية». هذا هو عيب نجاد. أما حسنته فهي أنه، وبعد انتزاع البلدية، قد رفض السكن في قصرها وفضل الإقامة في بيته الشخصي المتواضع والتوجه إلى مركز عمله في سيارة تعود إلى العام 1975... أي إلى ما قبل انتصار الثورة!لقد كان صعبا، قبل الدورة الأولى، تسمية المتنافسين في الثانية. إلا أنه أكثر سهولة اليوم ترجيح فوز رفسنجاني. فنجاد قد يكون عاجزا عن توسيع القاعدة التي اقترعت له. وإذا حصل ذلك فإنه قد يشهد انضمام قوى جديدة إليه لا حبا به وإنما كرها بخصمه، ورهانا على الالتباس في موقعه.كان يقال عن خاتمي أنه ليس معروفا ما إذا كان آخر المحافظين أو أول الإصلاحيين. والسبب في ذلك أنه كان يحاول ضبط الحركة الإصلاحية حتى لا تمس ثوابت الثورة الإسلامية، أي أنه كان يطلق السهم ويسعى إلى السيطرة عليه. ولقد أدى به ذلك إلى أن يخسر الإصلاحيين من دون أن يربح المحافظين الذين لم يغفروا له إلحاقه الهزيمة بهم ثلاث مرات في دورتين رئاسيتين وانتخابات بلدية. أي إن خاتمي كان ذا موقع ملتبس بين طموحاته وبين إدراكه لحقيقة موازين القوى وتمييزه بين المرغوب والمتاح. كان إصلاحيا يقمع نفسه. أما الالتباس في موقع رفسنجاني فأشد تعقيدا. صحيح أنه شديد الإدراك للعبة القوى ولكن الأصح أن أحدا لا يستطيع تصنيفه إلا بالقول إنه إصلاحي بين المحافظين ومحافظ بين الإصلاحيين. وأنه أصولي بين القوميين وقومي بين الأصوليين، وأنه معتدل بين المتصلبين ومتصلب بين المعتدلين، وأنه مدني بين العسكريين وعسكري بين المدنيين.. الخ.ولكن يبقى أن وصول رئيس البلدية إلى رئاسة الجمهورية هو في نظر صاحبه، نوع من ارتقاء وظيفي يهدد بإفقاد الموقع أهميته. ولكن وصول رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام إلى الرئاسة هو الإبقاء على ثنائية ما في قمة السلطة ولو أنها ثنائية تبقى لصالح خامنئي. ويمكن القول، من وجهة نظر إيرانية باردة، إن «المصلحة الوطنية» تقتضي أن يكون رفسنجاني رئيسا لأن البلاد تحتاج إلى من يشارك في إدارتها ، وإلى من يعالج آثار الصراعات في السنوات الماضية. وخصوصا، إلى من يمثل إيران حيال الخارج.وفي ما يخص النقطة الأخيرة، فإن هناك من يظلم الرجل إذ يعتبره ميالا إلى عقد تسويات سهلة مع الأميركيين. الحقيقة غير ذلك. إنه مفاوض صعب. وتكمن الصعوبة التي يمتلكها في قدرته على تقديم مواقفه المتصلبة في قالب معتدل وقادر على مخاطبة القوى المؤثرة في العالم. ولأن الإدارة الأميركية تدرك ذلك جيدا فإنها بادرت إلى التشكيك بنتائج الانتخابات قبل حصولها وستستمر في ذلك بغض النظر عن شخصية الفائز. فواشنطن تدرك، قبل غيرها، أنه في ما يخص الحلقات العالقة بينها وبين إيران فإن «العزة الوطنية» هي السمة المشتركة بين المرشحين كافة. أما رفسنجاني شخصيا فللولايات المتحدة تجربة مرة معه: هل هناك من يتذكر «إيران غيت»؟ كاتب لبناني |

| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||