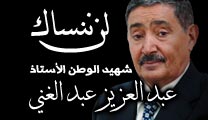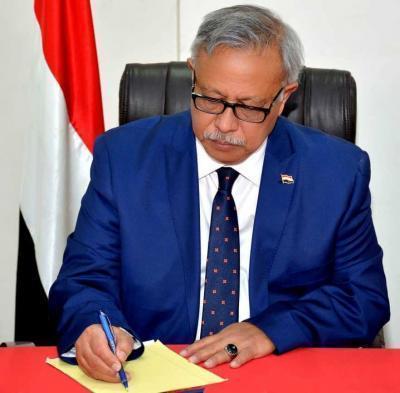على خارطة المطّاط يمكنك رؤية بيروت كاملة ثمة بالتأكيد شيء من الاستحالة المتأصّلة ترافق أي كتابة عن لبنان، وتحديداً عن بيروت. مصطلح "اللبننة"، المعبّر باختصار عن حالة "الافتراق والتمزّق في ما يفترض به أن يكون واحداً"، كان قد دخل النقاشات السياسية كمصطلح يشير الى الحروب الأهلية وإلى العنف الأعمى السائد خلالها. المصطلح ذاك، وأنا أحاول كتابة نص من التحليل الثقافي والانطباعات الخاصة بعد زيارة الى بيروت دامت أسابيع ثلاثة، يعاود طرح نفسه أمامي، لأكون أمام "لبننة" في معان أخرى. "لبننة" الدلالات اللفظيّة مثلاً، الممزّقة هي أيضاً والمتفرّقة والمتباعدة، عند نقاط الالتحام المفترضة. السبب في ذلك يعود ربما، وبحالة بيروت، الى أن من السهل ومن المغوي في آن الوقوع في شرك "الكليشيهات" الجاهزة: الماضي التليد، "لؤلؤة الشرق" و"باريس الشرق الأوسط" وقلبه الثقافي النابض، ثم فظاعة الحرب على مدى خمسة عشر عاماً حين حلّ الجحيم على الأرض. وفي ما بين هاتين الحالتين المتناقضتين يكمن الفراغ الكبير، لتغدو الدلالات اللفظيّة هناك، في ذلك الفراغ، بالنسبة للـ"أجنبي" المسكين الذي يحاول تكوين انطباعاته من خلال المظاهر المتناقضة، في حالة من التشتت والشلل التام. النتيجة الطبيعية لذلك الشلل في الدلالات اللفظيّة الشائعة، بالنسبة لزائر مشاكس وعنيد، تكون حاسة تحليلية مضاعفة النشاط، فتبدو بيروت معها، كمدينة وكمكوّن ثقافي وكجرح تاريخي، مصدر تحدّ ومعاندة. لكل حكاية هناك، حكاية معاكسة في المقابل. أمّا مساءلة التاريخ فلا تنتج أجوبة، بل تراكم أسئلة جديدة. في كل بناية كان الرصاص قد نخرها وأعيد ترميمها، أو ما زالت بحالتها الحربية، ثمة ما هو شبحي يسكن. وبموازاة السجالات السياسية التي تدور ثم تقفل، ثمة سجالات سياسية جديدة تتناسل. محاولة تكثيف ملاحظاتي تجاه أنشطة ثقافية راهنة في بيروت، ليست سوى محاولة للتعاطي مع أرضيات تلك الأنشطة وخلفياتها. بشكل عفوي، قد لا تلامس انطباعاتي تلك سوى مستوى السطح الخارجي للأمور، ملتقطة فقط بعض الملاحظات العابرة. لكن، وكما هو الحال في بيروت عادة، فإن ما بين السطح والداخل المختبئ توتّرات وعلاقات دائمة لا تتوقف. قد يرى البعض أن بيروت ما بعد الحرب هي فقط ذلك السطح الخارجي، المتجسّد بوسطها المعاد بناؤه وبتلك المطاعم والبارات الحديثة في الجميزة وشارع مونو. على أن المعاني الجوهرية للمدينة ربما، قد لا تظهر سوى هناك، في ما بين السطح الخارجي والعمق المختبئ. العديد من الفنانين المعاصرين، ومنذ بداية عملهم الفني وحتى تمثّل ذلك العمل ناجزاً، بدا وكأنهم يخوضون في استراتيجية تسعى لحفر واختراق ذلك السطح الخارجي. الممارسات الفنية لهؤلاء الفنانين تبدو كمحاولات لخدش الفجوة في الذاكرتين التاريخية والثقافية، وهي فجوة ليست غريبة عن مجتمعات تحيا هزّات ارتدادية لصدمات سابقة أصابتها. وصلت الى بيروت تماماً بعد مضي يوم واحد على جنازة تشييع رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، فتمثّلت أمامي مدينة في حالة حداد. الصور، الملصقات، اللافتات القائلة بمتابعة مسيرة الحريري، كانت في كل مكان. المواطنون كانوا ما زالوا في حالة صدمة وأسى. فبعد مضيّ أكثر من عقد من السلام النسبي، جاء الاغتيال ليستحضر الكثير من ذكريات الحرب الأهلية. ذكريات حاولوا دائماً تناسيها. ارتجافة أصابت جسدي ونحن ندخل المدينة، حين عبرنا لافتة تقول: "شاتيلا". قبل ذلك، وفي مكتب للصرافة في المطار، حيّرتني فكرة شيوع تداول الدولار بشكل يوازي تداول الليرة، العملة الوطنية. وقد ازداد ارتباكي، لغوياً فيما بعد، حين لاحظت أن اللغة العربية المستعملة كثيراً ما تطعّم بالفرنسية والإنكليزية. وأن الفرنسية تطعّم بالإنكليزية والعربية. والإنكليزية بالعربية والفرنسية. هكذا تبدو الصيغة اللبنانية وكأنها تعمل بالوكالة، أو عن طريق التفويض، سواء ارتبط ذلك بالاقتصاد أم بشؤون اللغة والتخاطب. ولسوء الحظ يمتدّ أسلوب التفويض المذكور ليشمل النظام السياسي أيضاً. إذ كثيراً ما يدور الحديث عن أن لبنان كان مسرحاً لحروب تجرى بالوكالة على أرضه، مسرحاً لصراعات قوى خارجية، وهذا يشمل الكلام عن الحرب الأهلية التي عمّت أراضيه منذ عام 1975 الى 1990. فكيف إذن، يمكن لنا مقاربة مظاهر الإبداع الجمالي وتقاطعها مع الواقع الاجتماعي السياسي، محافظين على مبدأ الحياد، في بيئة تضمّ ناشطين هم على ارتباط وثيق بكل ما يحصل حولهم. ناتالي فلاّحة، مصممة الغرافيكس والأستاذة في الجامعة اللبنانية الأميركية تستعرض في مشروعها الفني "رحلة طوبوغرافية عبر اللغات المتعددة" (1999) تحوّلات الخطاب المرتبطة باللغة المستخدمة، إنكليزية كانت أم عربية أم فرنسية، وهي تحوّلات ترتبط في النهاية بقضايا الهوية. استخدمت فلاّحة في مشروعها ذاك مقابلات أجرتها مع مثقفين وسياسيين سئلوا عن علاقتهم باللغة التي تكلّموا بها. وقد اعتمدت وسيلة إظهار "لغوية ـ طوبوغرافية" تم من خلالها إعادة رسم ملامح الهوية اللغوية لكل مشارك في المقابلات. الأسلوب المذكور في إعادة رسم الخرائط، يعتمد وسائل استراتيجية تُسقط على مجمتعات شهدت ـ ولا تزال ـ انقسامات متعلّقة بالإقرار بالمسؤوليات. مقاربة أكثر تكتيكية لخرائط المكان، تتجسّد في العمل التجهيزي لمروان رشماوي تحت عنوان "بيروت كاوتشوك" (2003"). العمل المذكور هو عبارة عن خريطة ضخمة لبيروت تمّت صناعتها من مادة كاوتشوك إطارات السيارات، بحيث يمكن للمشاهدين وطء تلك الخريطة والتجوّل عليها. التنقّل خلال ثوان بين منطقة وأخرى من بيروت في خريطة الرشماوي، يستحضر جهود العبور بين مناطق بيروت وخلال الحرب، التي كانت مقرونة بمعاملات اجتياز حواجز التفتيش وبالمخاطرات الصعبة. حتى اليوم، لا يزال التنقّل عبر الجسور وبواسطة السيارات، يعد الطريقة الأسرع للانتقال بين جزئي العاصمة. ما تقدّمه خريطة رشماوي المطاطية أيضاً، وبالتناقض مع الخرائط الاعتيادية للمدن، هو ذلك اللون الرمادي القاتم الوحيد، الخالي من أي رمز يشير الى أي علامة مدينية (فنادق، مصارف، مساجد، كنائس، مراكز سياحية... إلخ)، متجاوزاً بذلك تفاصيل المدينة المرتبطة بفروقاتها الطبقية والدينية وغيرها. فبإمكانك هكذا، الوقوف على جزءي بيروت، تاركاً آثار قدميك على الجزءين بالتساوي. محاولة الوصول سيراً على الأقدام الى "داون تاون" بيروت ـ أو المنطقة المعروفة بوسط بيروت ـ باتت عادتي الروتينية في كل يوم للانضمام الى تلك الاعتصامات اليومية التي كانت قائمة خلال زيارتي. "ثورة الأرز"، كما أطلقت الصحافة العالمية عليها، أو "ثورة الغوتشي"، كما لقّبها بعض المشككين المحليّين، ضمّت الكثير من البيروتيين الميسورين، المتّهمين في العادة باللامبالاة السياسية. المشاركون في الثورة تلك نزلوا الى الشوارع بأعلامهم اللبنانية، وهتفوا "سوريا آوت" و"حرية، سيادة، استقلال" و"حقيقة، حرية، وحدة وطنية". الـ"ستيكرز" الموزّعة واللافتات المرفوعة أخذت تطالب بـ"الحقيقة" فيما يتعلّق باغتيال الرئيس الحريري. هكذا مفاهيم، كمثل "الحقيقة" وما يلحقها من تعديلات إعلامية وفبركة، تثير شيئاً من الإحساس بالمرارة في هذا البلد الذي سبق أن شهد كم تصبح تلك القيم مرنة وقابلة للتطويع في خضمّ الصراعات. إنه ذلك الإعلام، غير الملائم لحمل ونقل القيم الإنسانية العليا ـ فلنقل ـ هو الذي يتناوله ربيع مروّة في عملي الفيديو والبيرفورمنس اللذين حقّقهما. في عمله الذي امتدحه النقاد (عرض في أمستردام الشهر الماضي) "البحث عن موظّف مفقود"، يتناول مروّة قضية اختفاء أحد الموظفين في وزارة المال اللبنانية منذ سنوات عدة. مادة عرضه هي مجموعة من دفاتر الملاحظات التي جمع فيها كل ما وصل إليه من أخبار الصحف المتعلّقة بقضية اختفاء رأفت سليمان، الذي يزعم أيضاً أنه اختلس من الوزارة مبلغ يقدّر بمليارات الليرات اللبنانية. مشاهدو عرض مروّة يتابعون "بروجيكشن" من ثلاثة أقسام، أحدها يظهر لوحاً للرسم يقوم فنان يجلس بين الحاضرين، بإنزال عليه وبشكل مباشر المخططات والرسوم التوضيحية للمعلومات المستلّة من مقالات صحف عدة، تلك المقالات المتنوّعة التي تشير وتظهر الى أي مدى قد تكون الحقيقة نسبية. عرض البروجكشن الآخر يظهر مروّة، الجالس خلف الحاضرين، وهو يستعرض مقالات الصحف. فيما خصص البروجكشن الثالث ليظهر دفاتر الملاحظات التي أرشفت فيها المقالات. عرض "البحث عن موظّف مفقود" يتألف من مادة توسطية مثلّثة، وهو إذ يقدم، وتستعرض رواياته المتعددة المصادر، التي تبيّن مقدار السخف المتضمّن في عمليات البحث التي كانت تجري عن الموظف المختفي، يختتم بظهور تدريجي وضمني للحقيقة. عرض نقدي قاس للممارسات الصحافية ولمظاهر الفساد ووسائط التعبير والاتصال، حيث "ما بين الحقيقة والكذب ليس أكثر من شعرة". بمزاج متقارب، عمله الفيديو الموقّع تحت عنوان "وجه أ وجه ب" (2001)، ينطلق من شريط كاسيت مسجّل في عام 1978 ومرسل الى شقيقه الذي كان يتلقى تعليمه في الاتحاد السوفياتي. مروّة يستخدم في العمل الأخير مادة من تاريخه الشخصي، كما يجري محاولة "لتفكيك" مادة الفيديو، التي يستخدمها في الوقت الراهن، وذلك عن طريق التركيز على قصور ما يقدمه الصوت بلا صورة، أو الصورة بلا صوت، أو التركيز على ميزة ذلك الأسلوب وإمكانياته. على أنه يمكن القول، أن كل مادة تبقى قاصرة في نقل الحميمية. بلا شك، إحدى النتائج الجانبية لانعقاد الاعتصامات الحاشدة والتجمّعات الطلابية التي أقامت في ساحة الشهداء في بيروت ردحة من الزمن، عملت على ترسيخ الوسط المديني المستعاد أكثر فأكثر كمكان عام. واقعة في قلب الخط الأخضر الذي فصل شرق بيروت عن غربها، كانت ساحة الشهداء (قلب بيروت قبل الحرب) قد تحوّلت الى أرض خراب، الى أن قام رفيق الحريري وشركة سوليدير للإعمار بإطلاق ما وصفه ساري مقدسي بـ: "أحد أكبر مشاريع الإعمار المديني في العالم المعاصر". هدف سوليدير كان يقضي بإعادة إعمار وترميم وسط المدينة وإعادته الى حالته السابقة. لكن ما حققته الى الآن في الواقع، هو حالة نوستالجيّة لا سابق لها، مفعمة بالأسلوب المعولم. للجولة في وسط بيروت أثر سوريالي في النفس. الأبنية مقامة بتكلّف واتقان. الألوان فاقعة بعض الشيء، وآثار الحرب وجروحها اختفت تحت طبقات كثيفة من الطلاء. الى ذلك، والأكثر تعبيراً في الأمر هو قلّة المتنزّهين في الشوارع. وسط بيروت هو أكثر مناطق المدينة تنظيماً وإدارة. خال من كل الأخطاء البشرية والتاريخية والمعمارية. استئناساً بتشبيه مادي، قد يزعم المرء أن شيئاً من "اللبننة" المعمارية قد ظهرت. المباني أفرغت من دواخلها وتركت واجهاتها، في ظاهرة أشبه بالعمليات الجراحية البلاستيكية. إتقان وبلاستيكية والكثير من مظاهر المكياج لإخفاء الرضوض والخدوش. مشروع لميا جريج الوثائقي والتجهيزي "أشياء الحرب" (2000 و2003)، هو بالتأكيد عمل لا يسعى الى إخفاء خدوش الحرب ورضوضها. كما أنه، وفي الوقت عينه، يظهر الى أي مدى قد يجد الناس ملجأ وأماناً في أشياء حياتهم اليومية، وسط حالات العنف القصوى وانعدام القيم. جريج تسأل الذين تقابلهم عن شيء ما يذكّرهم بالحرب. تقوم جريج بتصوير أشخاصها في منازلهم، حيث تطلب منهم رواية حكاياتهم مستعيني بأشيائهم الخاصة التي تغدو كعربات تحمل ذكرياتهم من الماضي وتنقلها الى الحاضر. فانوس صغير، مطرة مياه، ورق لعب، بطاريات للراديو، تنكة بيرة مخبأة بأوراق الكلينكس عندما أصبحت البيرة محظورة في بعض مناطق بيروت خلال الحرب. جريج تحاول القول إن كل حرب هي مأساة فردية خاصة، وإن كل رواية عنها قد تحمل ذلك التأويل الشخصي الذي يختلف بين امرئ وآخر. الى ذلك، تؤكد جريج على ضرورة سرد الحكاية وإعادة سردها، في محاولة للفهم وحلّ الرموز الملغّزة. التكرار بلا نهاية واضحة هو ثيمة تميّز عملها (الفيديو ـ التجهيزي) الموقّع تحت عنوان "إعادة" (2000). العمل يستند الى صور فوتوغرافية منشورة في كتاب يتناول الحرب الأهلية صادر عام 1979، تظهر رجلاً تلقى إصابة بالرصاص وامرأة تحاول الفرار. جريج في عملها استعانت بممثلين لإعادة تركيب المشهد. مشهدها المتكرّر ذلك، يوحي بغموض دوّمات العنف، وبقدرة التكرار على تخدير الإدراك الحسي وإخماد الحواس. ترجمة: فادي طفيلي نات مولر منشّطة فنية هولندية |

| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||